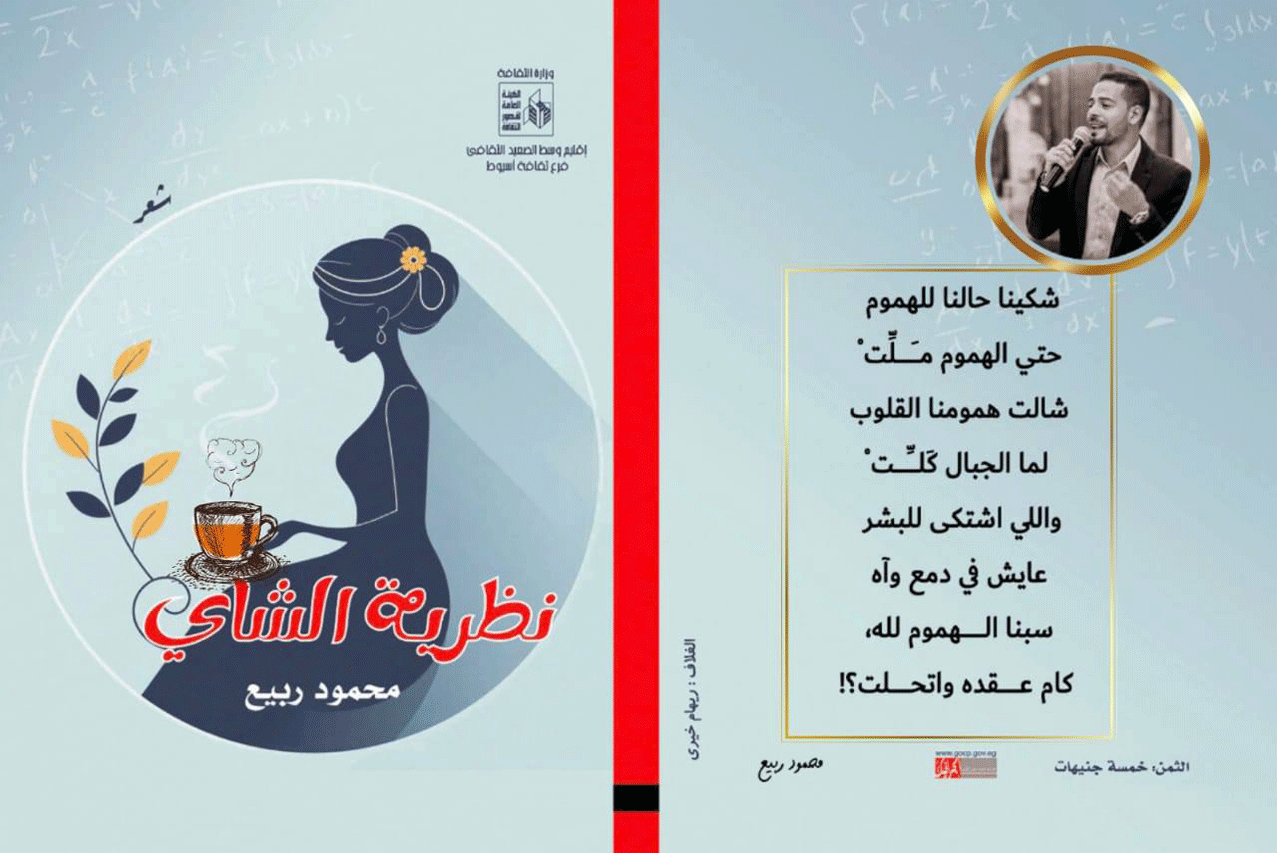جابر الزهيري يكتب: تقنية الحوار السردي في النص الشعري قراءة نقدية في ديوان نظرية الشاي للشاعر محمود ربيع الشاعر محمود ربيع
الشعر هو فن العربية الأول، وبه خلد الشعراء أمجاد قبائلهم، ودونوا من خلال ما يكتبون مآثرهم، وانتصاراتهم، حتى صار الشعر ديوانا للعرب، وقد جمع الشاعر العربي من فنون القلم بالشعر تقنيات متعددة منها تقنية القص بداخل القصيدة، فيحول النص الشعري لما يشبه (الحكاية) أو القصة بدمج السرد القصصي لحدث معين في إطار القالب الشعري، والنماذج متعددة كما في معلقات امرؤ القيس وعمرو بن كلثوم وعنترة، ومن أهم تقنيات السرد الدرامي تيمة الحوار، حيث يتم التفاعل الحواري بين الشخوص لينسجم البناء السردي، وهذه التيمة أيضا ظهرت بجلاء فيما ذكرت من معلقات الشعر القديم، أي أن تلك الظاهرة وإن كانت موغلة في القدم، واستخدمها فحول الشعر وسلاطينه منذ بدايات شعر ما قبل الإسلام إلا أن الشعر الحديث حتى بعد أن ظهرت مدارس جديدة لكتابة الشعر وتغير الشكل التقليدي للقصيدة من البيت الشعري الكلاسيكي إلى سطر قصيدة التفعيلة (الشعر الحر) أو النصوص الحداثية أو ما بعد الحداثية سواء ما كتب باللغة الفصيحة أو باللهجات الدارجة للشعر الشعبي، إلا أن تلك التقنية راسخة في وجدان الشعراء وظاهرة تستحق الملاحظة والبحث في الشعر الحديث.
تقنية الحوار السردي في النص الشعري هي أسلوب يجمع بين عناصر السرد والحوار، لخلق تجربة أدبية أكثر تفاعلية وجاذبية، تعمل هذه التقنية على تمرير الأحداث، وكشف تطور الشخصيات، سواء كانت حقيقية أو اعتبارية رمزية أو تخيلية، وتقديم وجهات نظر مختلفة، مما يضيف عمقًا وتنوعًا في الإيقاع والبنية إلى القصيدة.
ويُمكن أن يشمل هذا النوع من الحوار حوارًا داخليًا بين الشاعر ونفسه، أو حوارًا خارجيًا مع شخصيات أخرى، أو مع الذات الغائبة، مما يمنح النص الشعري أبعادًا درامية ومتعددة الأصوات.
وفي ديوان (نظرية الشاي) للشاعر محمود ربيع نلاحظ وجود هذه التقنية بوضوح منذ الكلمات الأولى في القصيدة الأولى، فيقول مخاطبا الأم:
يا أجمل كلمة ينطقها لسان إنسان
يا نـــبع حنـــــان
يا ست الكل وحشاني
يا مالكة كل وجداني.
فيبدأ بالنداء وهو أول مراحل الحوار، ويكرره لأربع مرات بصفات مختلفة للمنادى، وكأنه يستجدى تلبية النداء بالدخول في الحوار مع الشخصية الغائبة، ثم يسرد وصف حاله لها في سرد درامي بلغة الشعر الرقيقة حتى يصل إلى نهاية النص بنفس أداة النداء فيقول: يا ست الكل وحشاني.
وكذلك بنفس التيمة والمفردات والأسلوب يدخل محمود ربيع للنص الثاني ولكن المنادى هنا يترك الشاعر تأويله للقارئ فيجله يحاول استنتاج الشخصية، فهل هي الأم / الحبيبة/ الابنة/ الوطن… فقد أفصح من خلال الإهداء عن شخصيات تستحق أن يكون لها ما كتب، ولكن النص يحتمل أن يكون لأي منهن أو لهن جميعا في إيقاع متناغم لتفعيلة بحر الهزج.
ثم ينتقل إلى محاورة الذات وإن كانت تظهر كمحاورة مع الغير من خلال السؤال والجواب في قصيدة (عساك تقدر) لكنها في الأساس تعد كتوضيح لمعاناة مجتمعية انتقل فيها الشاعر من الذات إلى العموم، وهو ما وضحته القصيدة التالية التي وضحت أنماط الشباب في جعل كل مقطع يظهر صفة مميزة لكل نمط، ودون وعي يكتشف الشاعر أنه يقص بالسرد الدرامي داخل النص فيختمها بقوله: قصة جد ومش هزار. كذلك في قصائد كله رايح، ولمين يا غريب؟ وإن كانت تحمل من الذاتية أكثر مما تحمل من محاورة للغائب، فما ذلك الغريب إلا الذات الغائبة في غربة النفس.
وفي قصيدة الديوان (نظرية الشاي) يتضح لنا براعة الشاعر في استخدام تلك التقنية من خلال الحوار السردي داخل النص الشعري فيقوم تطوير الشخصيات وتعميق البعد النفسي، فيجعل الشخص الآخر (الزوجة) شريكا في العمل من خلال السرد القصصي والحوار المتداخل، في قصيدة ماتعة تحمل رؤية وإن بدت ساخرة إلا أنها نظرية حداثية ابتكرها الشاعر في التعامل الفكاهي بين زوجين، حيث ساهم تناوب السرد والحوار في خلق إيقاعات متنوعة داخل القصيدة، فالحوار يسرع وتيرة الأحداث، بينما يتيح الوصف والسرد الهادئ فرصة للتأمل وتغير الحالة النفسية للقارئ.
ويمكن للحوار أن يكشف عن تفاصيل الأحداث أو يفسر دوافعها، مما يساعد القارئ على فهم سياق القصيدة وعمق معانيها، واستنتاج الشخصية التي يحاورها الشاعر (إذا لم يذكرها صراحة داخل النص) كما في قصائد ليه الخصام؟، و لو قالولك، بتوحشني، وإن كانت غالبية القصائد التي تحمل الحوار إلى الأنثى موجهة إلى الأم، سواء بصريح اللفظ أو باستخدام تقنيات الرمز الدلالي كما في قصائد بيت العز وحضن الوجع، وعرفت ازاي؟ ورؤية و بشتاق لها، وانتي مين؟ و غيرك ماليش
ومع تعدد الرؤى ووجهات النظر، يسمح الحوار بتقديم وجهات نظر مختلفة، مما يخلق ثنائية في الرؤية والتفكير داخل النص الشعري، ويثري تجربة القارئ الفكرية بكسر الرتابة، فيميل محمود ربيع لتيمة النقد الساخر في قصيدة كورونا تجدوا ما يسركم، وخاصة باقتباس جملة شهيرة من مسرحية، وأيضا في قصيدة دموع الفرحة، و حالة وأخواتها، وكلام في كلام.
وللمناسبات نصيب كبير في ارتباط السرد الدرامي بالزمن والمكان، فتجلى ذلك في قصائد هل هلاله، والمسحراتي لسرد ذكريات عن شهر رمضان بأسلوب شعري رقيق يخرج النص عن إطار النظم التقليدي لشعر المناسبات.
ومن الأمثلة الجيدة للسرد الحواري مع وعن شخصيات محددة شكلت الروح الشاعرة والنفس الإنسانية للشاعر نجده بمنتهى الصدق الفني يكتب سلام لأبويا فيقول:
أبويا وجوده في الدنيا
ده أكتر شيء مطمني
وبرفع راسي تلقائي
لو ألمح طرف جلابيته
أنا قبل أما أكون نطفة
عشقته يا ناس وحبيته
وحبيت التـــــراب في الأرض
لو يمشي عليه ويدوس.
وأيضا بنفس أسلوب السلام يوجه سلاما مؤقتا للرجل الثاني الذي ارتبط به كمثل أعلى وهو الخال حسين نصار (وكما أشرت أن محمود ربيع جمع كل أبطال قصصه الدرامي في قصائد الديوان في كلمات الإهداء وفاء لهم) وأكمل شخصياته بشخصية اعتبارية وهي بلدته (ديروط الشريف) التي أفرد لها قصيدة أماكن بالقلب.
فهكذا يساهم الحوار في كسر جمود النص السردي وكسر رتابة الوصف، مما يجعل النص الشعري أكثر حيوية وتشويقًا للقارئ، سواء كان حوارا داخليا أو مع الآخر، من خلال الحوار الدرامي في سياق القصيدة، وقد يحاور الشاعر شخصية غائبة أو روحًا، مما يفتح مجالًا للتأمل واستعادة الذكريات.
ويتداخل السرد والحوار معا في سياق النص الشعري ليتم تقديم الأحداث والوقائع بشكل يجمع بين السرد التقليدي وأصوات الشخصيات الحوارية، مما يخلق تفاعلاً غنيًا بين القصة والشخصيات.
فالحوار من حيث أداؤه السردي، والدور الذي يضيفه للشعر حين يستعير هذه الأداة الفنية بوصفه تقنية سردية أو درامية، و بما يضيفه الحوار إلى شعرية القصيدة، وباعتماده أدوات الشعرية ونظرياتها ومناهجها النقدية؛ يجعلنا نلاحظ أن الشاعر محمود ربيع قد استثمر الحوار بطريقة خدمت شعرية نصه، وأعاد به ترتيب النموذج التواصلي بما يبرز مشاعره -في إيقاع مختلف- محملاً مفردات السرد حمولة شعرية تستنطق العوالم الداخلية للذات، وتعيد تشکيلها وفق رؤيته.

بقلم
جابر الزهيري
عضو اتحاد كتاب مصر